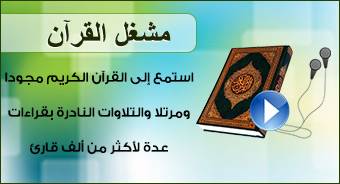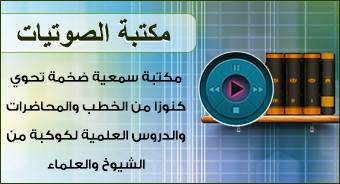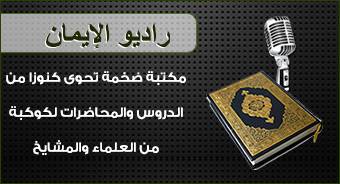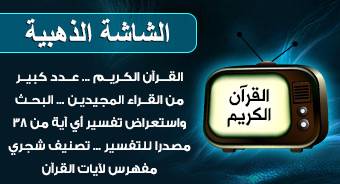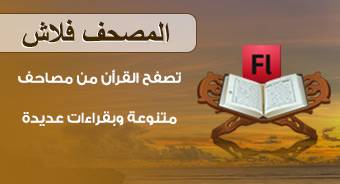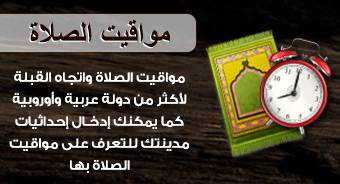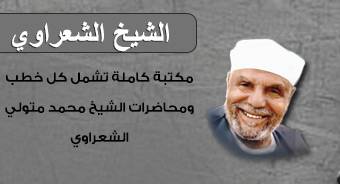|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
واصطلاحا: جاء في (الاختيار): المدعى: من لا يجبر على الخصومة. والمدعى عليه: من يجبر. - وفي (دستور العلماء): اسم الفاعل من إذا ترك دعواه ترك: أي لا يجبر على الخصومة إذا تركها، لأن له حق الطلب، فإذا ترك لا سبيل عليه. واسم المفعول: هو الذي ادعاه رجل فيطلب الدليل عليه، ولذا يسمى مطلوبا، والمدعى والمطلوب والنتيجة متحدة بالذات ومتغايرة بالاعتبار. - وفي (شرح حدود ابن عرفة): المدّعى: من عريت دعواه عن مرجّح غير شهادة، والمدعى عليه: من اقترنت دعواه به. - قال الدردير: المدعى: هو الذي تجرد قوله عن أصل أو معهود عرفا يصدقه حين دعواه، فلذا طلبت منه البينة لتصديقه، والمدعى عليه: من ترجح قوله بأصل أو معهود. - وفي (التعريفات): المدّعى: من لا يجبر على الخصومة، والمدعى عليه: من يجبر عليها. [الاختيار 2/ 144، ودستور العلماء 3/ 232، وشرح حدود ابن عرفة ص 609، والشرح الصغير 4/ 18، والنظم المستعذب 2/ 357، والتعريفات ص 183].
مدد، مثل: غرفة وغرف. ولها استعمالات أربعة في الفقه الإسلامي: 1- مدة الإضافة. 2- مدة التوقيف. 3- مدة التنجيم. 4- مدة الاستعمال. والمدّة- بالكسر-: ما يجتمع في الجرح من القيح. [أنيس الفقهاء ص 55، الموسوعة الفقهية 24/ 6].
وفي (شرح الكوكب المنير): المقصود منه ذكر القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم. وفي (التعريفات): هو الذي أدرك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح. [دستور العلماء 3/ 232، 236، وشرح الكوكب المنير 1/ 30، والتعريفات ص 183].
[نيل الأوطار 7/ 26].
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 617].
[نيل الأوطار 4/ 159].
[الحدود الأنيقة ص 80].
[دستور العلماء 3/ 232].
وفي الحديث: «ليس معنا مدى، فقال- عليه الصلاة والسلام-: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا». [البيهقي 9/ 246]. وأنهر الدم- بفتح الهمزة، ونون، وراء-: أي ما أساله حتّى جرى كالنهر الذي يجري فيه الماء. [المغني لابن باطيش ص 305].
وفي (دليل السالك): هو الذي يبيع بالسعر الواقع أو لو كان فيه خسارة، ويخلف ما عنده بغيره كأرباب الحوانيت. والظاهر: أن أرباب الصنائع كالحاكة والدباغين مديرون. وفي (المدونة): نص على أن أصحاب الأسعار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان أنهم مديرون، وكذلك صناع الأحذية مديرون، لأنهم يصنعون ويبيعون أو يعرضون ما صنعوه. أما المحتكر: فهو الذي ينتظر ارتفاع الأثمان فشأنه أن يرصد الأسواق بغية تحقيق الربح بارتفاع الأسعار. [دستور العلماء 1/ 474، وبلغة السالك 1/ 473، 474، ودليل السالك ص 35، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 145].
ومدن المدينة: أتاها، ومدن المدائن: مصرها. والمدينة: مشهورة معروفة شرفها الله تعالى على سائر البلاد والأمصار، لما هاجر نبينا صلّى الله عليه وسلم من مكة المعظمة أقام بالمدينة المنورة حتى توفى فيها. ولا يجوز نزع الألف واللام منها إلا في نداء أو إضافة، ولها أسماء: المدينة، وطابة، وطيبة، بفتح الطاء، وقيدته بفتح الطاء احترازا من طيبة بكسرها، فإنها قرية قرب زرود، ويثرب، كان اسمها قديما، فغيره النبيّ صلّى الله عليه وسلم لما فيه من التثريب، وهو التعيير والاستقصاء في اللوم، وتسميتها في القرآن (يثرب) حكاية لقول من قالها من المنافقين، وقيل: يثرب: اسم أرضها، وقيل: سميت يثرب باسم رجل من العمالقة كان أول من نزلها، وقال عيسى بن دينار: من سمّاها يثرب كتبت عليه خطيئة. فائدة: تعريف المدينة، والقرية ونحوهما:
بلد بالمكان يبلد بلودا: أقام.
أمصار، ومصر المكان: جعله مصرا فتمصر.
أحياء.
حلال وحلل، والمحلال: المكان يحل فيه الناس.
وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه خرج إلى الشام فلقيه أمراء الأجناد، وهي هذه الخمسة الأماكن، كل واحد منها يسمى جندا: أي المقيمين بها من المسلمين المقاتلين. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 552، 553، ودستور العلماء 3/ 233، وأنيس الفقهاء ص 128، 129، وتحرير التنبيه ص 156، والمطلع ص 158، 183، 184، 226].
قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له. وقال ابن خروف: إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به، وأطلق على الكل اسمه، فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل. [نيل الأوطار 1/ 246].
هو الذي أمّه من العتاق وأبوه دون ذلك، قيل: سمّى بذلك للرّقمتين اللتين في ذراع البغل الذي أبوه حمار، فهو اسم لمن أمّه عربية وأبوه خسيس غير عربي، قال الفرزدق: [المغني لابن باطيش ص 413، والنظم المستعذب 2/ 53].
هو البسر الذي بدأ فيه الأرطاب من قبل ذنبه فحسب. قال الجوهري: وقد ذنبت البسرة فهي: مذنبة. [المطلع ص 390، تهذيب الأسماء واللغات ص 112].
وفي (الكليات) المذهب: المعتقد الذي يذهب إليه، والطريقة، والأصل، والمتوضأ. [الكليات ص 868، والتوقيف ص 646].
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المذي: هو الذي يكون مع الشهوة يعرض من القلب، ومن الشيء يراه الإنسان. وسئل عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هو الفطر. قال أبو عمر: الفطر أقوى، والله أعلم. إنما سمى فطرأ، لأنه شبه بالفطر في الحلب، وهو: الحلب بأطراف الأصابع فلا يخرج اللبن إلا قليلا، وكذلك يخرج المذي وليس المنى كذلك، لأنه يحذف حذفا. وقال بعضهم: إنما سمّى فطرأ، لأنه شبه بفطريات البعير، يقال: (فطرنا): به إذا طلع، فشبه طلوع هذا من الإحليل بطلوع ذلك. ويقال منه: (مذي، يمذي، مذيا)، ومنه قولهم في المثل: (كل فحل يمذي، وكل أنثى تقذى). ويقال أيضا: (أمذى يمذي إمذاء، ومذّ يمذّي تمذية). وقال ثابت في (خلق الإنسان): المذي- سكون الذال-: الفعل،- وبكسرها-: الاسم. فعلى هذا يكون التشديد أحسن، لأنه الاسم الذي يوصف بالخروج لا الفعل. واصطلاحا: جاء في (الدستور): هو الماء الغليظ الأبيض الذي يخرج عند ملاعبة الرجل أهله، وهو ناقض الوضوء لا الغسل فلا يجب الغسل عنده. - وفي (شرح الزرقانى): هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكّر الجماع أو إرادته وقد لا يحس بخروجه. - وفي (المغني لابن باطيش): هو ما يخرج من ذكر الإنسان عند الملاعبة والتقبيل والنّظر، يضرب لونه إلى البياض.- وفي (الرسالة): ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار. - وفي (التنبيه): ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه ويشترك فيه الرّجل والمرأة، وكذا في (نيل الأوطار). - وفي (معجم المغني): هو ماء يخرج لزجا عند الشهوة على رأس الذكر، وهو يوجب الوضوء، وغسل الذكر والأنثيين، ويجزئه غسلة واحدة، سواء غسله قبل الوضوء أو بعده. [لسان العرب (مذي)، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 30، وغرر المقالة ص 82، وأسهل المدارك 1/ 19، ودستور العلماء 3/ 237، وشرح الزرقاني على الموطأ 1/ 83، والمغني لابن باطيش ص 51، والرسالة مع كفاية الطالب الرباني 1/ 49، 50، وتحرير التنبيه ص 43، 44، والمطلع ص 37، ومعجم المغني (238)، واللباب شرح الكتاب 1/ 17، ونيل الأوطار 1/ 52]. |